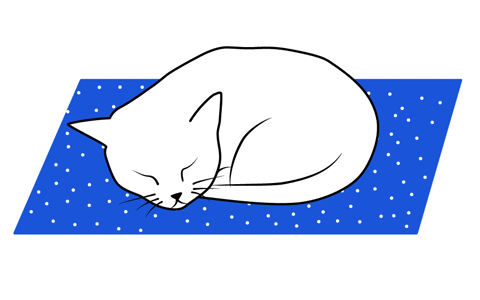حلم ليلة عيد
فاطمة محمد
أحملُ حزني بداخلي كأنه بنطال جينز مبتل، ولا يجففه شيء. أتخيل أنني أخرجه حين أتحدث، حين أكتب، أتخيل أنني أقوم بتجفيفه، ولكن يا إلهي إنه لا يجفّ. أحيانًا لا يكفي أن نمشي حتى نبتعد، لا يكفي أن ننظر للأمام حتى لا نرى الخلف، لا يكفي أن نصرخ ليسمعنا أحد. ودائمًا لا يكفي أن نلوّح حتى نودع الآخرين. أعرف أننا لا يمكن أن نتخلص من الأشياء حين نلفظها أو نرفضها، ستبقى موجودة، ستعلن عن وجودها بوقاحة كما تفعل إسرائيل التي تعرف أنها أشد أبناء الحرام حرامًا ومع ذلك تعلن عن نفسها. نحن لا ننسى حين ننوي كما يبدو، “يا إلهي ماذا عليّ أن أفعل لأترك الماضي ورائي ويبقى هناك حيث هو؟”.
في هذه الأيام أحاول تعديل نومي، أن أضبط منبهي البيولوجي ليستيقظ صباحًا ويخلد للنوم ليلًا، لا شيء قادر على تحسين مزاجي وتهدئة نفسي أكثر من النوم المعتدل، أفكر كم هو هش هذا الإنسان. هش وضعيف ويشعر بالخوف في أغلب الوقت. وقد يدفعه شعوره بالخوف إلى ارتكاب الكثير من الفظائع. لن أستطرد هنا فأنا بحاجة للكتابة عن الآن واللحظة، أبحث عن التشافي بالكتابة، حيث أنني لستُ بحالٍ جيدة منذ مُدة، عصبية ومضطربة المزاج أغلب الوقت، ويكاد يقتلني القلق. أذكر أنني أُعجبتُ مرة بنصيحة جدّ إيزابيل الليندي لها، أن لا سبيل حيال المشاكل الحياتية سوى الضغط على الأسنان والمواصلة قُدمًا، ويبدو أن جسدي قد استجاب فعليًا لهذه النصيحة، ففي آخر زيارة لعيادة الأسنان، أخبرتُ الطبيب بما أعانيه من ألمٍ في أسناني، وتوصلنا إلى أنني أشدّ عليها أثناء النوم استجابةً لنصيحة عجوزٍ تشيلي قد مات منذ زمن، وكانت هذه طريقته ليواجه بها متاعب الحياة. ومن منظورٍ آخر قال هنري ميللر مرةً: “أحبّ دائمًا استعمال كلمة (تَقبُّل). إنها بالنسبة لي كلمة كبيرة، تقبُّل الحياة كما هي”.
لا أعرف في أي عمرٍ قرر ميللر أن يتقبّل الحياة كما هي، بعد أن صبّ شتائمه ولعناته عليها. لكنها مسيرة طويلة من السنين والمواقف، والآلام التي أوصلته لفكرة التقبّل، كخيار وحيد يمكنه من مواصلة الحياة بلا توقعات، بلا انتظار، بلا مزيد من الجهد المبذول سُدىً. أن ينظر للحياة بعقله لتبدو ملهاة كبيرة، مسرح دُمى تحركهم خيوط القَدر يمينًا ويسارًا، ومنهم تلك الدُمى المعلّقة أبدًا بلا حركة وفي اتجاه واحد.
أعتقد أننا حين نقرأ، فنحن نبني علاقة صداقة وإن كانت من طرفٍ واحد، هناك في مكانٍ ما من هذا العالم الواسع، أشخاص يتقنون التعبير عمّا نشعر به، أشخاص ربما لن نلتقي بهم أبدًا، ومع ذلك فهم أصدقاء، أتذكر مقطع من حوارٍ في فلم (قطار الليل إلى لشبونة): “تبدو الأمور أسهل وأوضح إذا تحدثنا بها مع غريب”، وأشعر أنه من المثير للدهشة أن تجد سطرًا من كتاب نُقل عبر لغتين، ويعبّر عما تشعر به تمامًا وكأن حروفهم مرآة لدواخلنا.
وبالحديث عن الأصدقاء، لا أذكر تحديدًا متى كانت المرة الأخيرة التي حصلتُ فيها على أصدقاء؟، ولا أريد أن أبدو كمن يحسب المكاسب والخسائر، لأن الأمر نسبيّ، وبعضهم كانوا كذلك لفترة، ثم انقطعت بنا سُبل الحياة، المهم هو حين نلتقي ما زلنا نكنّ الودّ، وما زالت وجوهنا تتبادل الابتسام، وتضيء العيون حين نلتقي ولو مصادفةً، ما زلتُ أتذكر صرخة (رغد) التي التقيتها مصادفة بعد سنوات في مواقف إحدى المجمعات التجارية كانت تلوح بيديها قبل الحُضن وصوتها يقترب: “يا محاسن الصُدف”.
ولينة التي تعيش في نيويورك منذ ٢٠١٢م تقريبًا، أحدثها قبل عدة أيام، وأحكي لها مقولة دارجة لم تفهمها، أضحك للاختلاف الثقافي الذي صار بيننا، ومع ذلك فلغة الضحك واحدة. ليست لينة صديقتي فقط، بل أم لينة أيضًا، خالة (فاطمة الشهيّب)، أم أحمد، الجميل الذي قرر منذ زمن أنه لن يكبر أبدًا، وعبر الشارع، وفي لحظة توقف عن النمو.
لا يكبر الصغار حين يرحلون، بل يظلون كذلك حتى بعد عشرات السنوات، يلوحون لنا في حلمٌ ليلة عيد، بوجوههم الصغيرة، وأسنانهم غير المكتملة. الصغار الذين ماتوا يعودون في ليالي الأعياد، وفي اجتماعات العائلة، حتى بعد أن امتلأ مكانهم حول مائدة الطعام، فهم يعرفون جيدًا أن مكانهم في القلب لن يُشغل أبدًا.
“يومًا ما سأوقف هذا الحنين، لكنه الآن، في كل مكان”.
عدد المشاهدات : 1200
شارك مع أصدقائك
One Comment