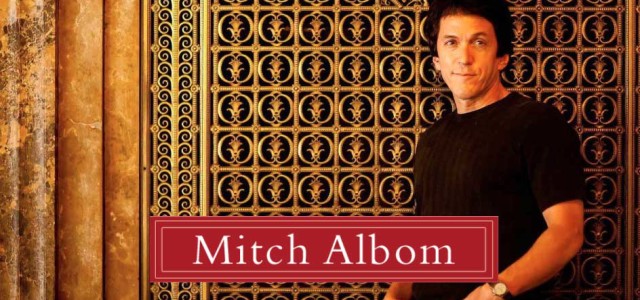ولو ليومٍ واحد آخر | ميتش ألبوم
سارة فهد
“قال لي والدي ذات مرة: «إما أن تكون ابن أمك أو ابن أبيك، لكنك لا يمكن أن تكون ابن الاثنين معًا». وعليه كنت ابنًا لأبي. كنت أحاكي مشيته. أحاكي ضحكته العميقة المفعمة بدخان السجائر. وحملت قفاز بيسبول، لأنه عشق لعبة البيسبول، والتقطت كل كرة قوية رمى بها نحوي، حتى تلك الكرات التي ارتطمت بيدي بقسوة شديدة لدرجة تجعلني أرغب في الصراخ. بعد خروجي من المدرسة كنت أركض نحو متجر العصائر والمشروبات الذي يمتلكه في كرافت آفينو وأبقى هناك حتى موعد العشاء، ألهو بالصناديق الفارغة في المخزن، في انتظار انتهائه من عمله، وكنا نعود معاً للمنزل مستقلين سيارته البويك سيدان ذات الزُّرقة السماوية. وأحياناً كنا نجلس في مدخل السيارات بينما يدخن سجائر الشستر فيلد ويستمع إلى الأنباء في المذياع.
كانت لي أخت صغرى اسمها روبرتا، وآنذاك كانت ترتدي حذاء باليه وردي اللون، وحين نكون بأحد مطاعم المدينة. كانت أمي تسحبها إلى حمام السيدات بينما يأخذني والدي إلى حمام الرجال وبعقلي الصغير أدركت أن هذه هي طبيعة الأمور: أنا مع أبي وهي مع أمي، حمام الرجال، وحمام السيدات، شيء للأمهات وشيء للآباء.
ابن أبي. كنت ابن أبي، وبقيت ابن أبي حتى صباح يوم أحد حار صافي السماء من ربيع عام الصف الخامس بالمدرسة. كان أمامنا في جدول ذلك اليوم مباراتان متواليتين ضد فريق الكاردينالز. كانت الشمس قد أدفأت المطبخ عندما دلفت إليه بجواربي الطويلة، حاملاً قفازيّ، ورأيت أمي جالسة إلى المائدة تدخن سيجارة. كانت أمي امرأة جميلة، لكنها لم تظهر بجمالها المعتاد ذلك الصباح، عضّت شفتيها وأشاحت ببصرها عني. أذكر رائحة الخبز المحترق وظننت أنها منزعجة لإفسادها خبز الإفطار.
قلت: «سآكل رقائق حبوب».
تناولت وعاء من الخزنة.
تنحنحت: «ما موعد مباراتك يا حبيبي؟».
سألتها: «لديك نزلة برد؟».
هزّت رأسها نفياً وأراحت يدها على وجنتها قائلة: «ما موعد مباراتك؟».
«لا أعلم»، هكذا قلت رافعاً منكبي، فلم أكن أرتدي ساعة يد وقتها.
تناولت زجاجة الحليب والعلبة الكبيرة لرقائق الحليب. صببت الرقائق بأسرع مما يجب فوقع بعض منها من الوعاء إلى سطح المائدة. التقطت أمي ما تناثر، واحدة واحدة، وأغلقت عليه راحة يدها ثم همست: «سأصطحبك إلى المباراة، أياً كان موعدها».
سألت: «ولماذا لا يصطحبني أبي؟».
«أبوك ليس هنا».
«وأين هو؟».
لم تُجِب.
«ومتى يعود؟».
اعتصرت رقائق الحبوب بين أصابعها فتفتت بين أصابعها وصارت مسحوقًا ناعمًا.
منذ ذلك اليوم فصاعدًا، صرت ابنًا لأمي.
بعد موت أمي بأعوام، وضعت قائمة للأوقات التي ساندتني فيها أمي، والأوقات التي لم أساند فيها أنا أمي، كان من المؤسف عدم التوازن بين هذه وتلك.
لماذا ينتظر الأطفال الكثير والكثير من أحد الوالدين ويرضى بأقل القليل من الآخر؟ ولعل الأمر على نحو ما أخبرني والدي: «إما أن تكون ابناً لأمك أو ابناً لأبيك، ولكن لا يمكنك أن تكون ابناً لكليهما». وهكذا يتشبث المرء بالطرف الذي يظن أنه قد يفقده».
*****
“تقول الحكاية إنها التقت بأبي على ضفاف بحيرة بيبرفيل في ربيع 1944. كانت تسبح وكان هو يلعب البيسبول مع رفاقه، ورمى واحد منهم بالكرة لأعلى من اللازم فسقطت في الماء. سبحت أمي لتلتقطها، وقفز أبي في الماء، وحين كان يخرج للسطح ومعه الكرة، ارتطم رأسُ كل منهما بالآخر. تقول أمي: «ولم نتوقف قط عن هذا الارتطام».
تقربا إلى بعضهما البعض بسرعة وبقوة، هكذا كان أبي يبدأ الأمور وهو يهدف إلى إنهائها، كان شاباً طويلاً قوي البنيان تخرج لتوه من المدرسة الثانوية، يصفف شعره للخلف بقصة عالية. ويقود سيارة والده من طراز لاسال بلونيها الأزرق والأبيض وقد سجل نفسه في قوائم المتطوعين لخوض الحرب العالمية الثانية بأسرع ما يمكن، وقال لأمي إنه يودّ أن «يقتل من الأعداء أكثر مما يمكن لأي رجل آخر في المدينة أن يقتل».
وارتحل بحراً إلى إيطاليا، وإلى بوفاري بالقرب من بولونيا. وفي رسالة وردت من هناك في عام 1945، طلب يد أمي. كتب: «فلتكوني لي زوجة». مما بدا أقرب إلى الأمر العسكري بالنسبة لي. وافقت أمي في رسالة الرد التي كتبتها على ورق خاص مصنوع من الكتّان، وهو ماكان مكلفاً للغاية بالنسبة لها ولكنها بطريقة من الطرق تدبرت أمر شرائه. أولت أمي احتراماً كبيراً لكل من الكلمات وما يُستخدم لنقلها. بعد أسبوعين من تلقي أبي لرسالة أمي، وقّع الألمان وثيقة الاستسلام، وعاد للوطن. إلا إنه في اعتقادي لم يكتفِ قط بالحرب التي خاضها، وهكذا صنع حربه الخاصة معنا”.
*****
“يثبت الآباء بوضعيات في ذهن الطفل، وكانت أمي هي امرأة تضع طلاء الشفاه ثم تنحني نحوي، وتهزّ سبابتها، مطالبة إيايّ بأن أكون أفضل مما أنا عليه، أما وضعية أبي فكانت لرجل ممسك بسيجارته يستريح بكتفيه على جدران، يراقبني من بعيد سواء كنت أسبح أو أغرق.
عندما أستعيد هذا الأمر ثانية، تتضح أكثر حقيقة أن أحدهما كان ينحني نحوي والآخر ينحني بعيداً عني، لكني كنت صبياً، وما الذي يعرفه الصبيان الصغار على أيّ حال؟”.
*****
”حياة كل أسرة هي قصة أشباح من نوع ما، فالموتى يتخذون مجالسهم إلى موائدنا لوقتٍ طويل بعد رحيلهم”.
*****
”تعمل الأمهات على تغذية أوهام بعينها داخل أطفالهن، وأحد الأوهام الخاصة بي هو أنَّني أحب نفسي على ما بها من عيوب، ذلك لأنها كانت تحبّني كما أنا. وعندما ماتت، غابت معها هذه الفكرة”.
*****
”عندما ينتزع الموت أم المرء، فإنه يسرق منه تلك الكلمة إلى الأبد. “أمي؟“. مجرد صوت صغير حقاً، همهمة يكاد لا يفتح المرء شفتيه لينطق بها. غير أن فوق هذا الكوكب ملايين وملايين الكلمات، ولا واحدة منها تخرج من الفم على النحو الذي تخرج به هذه الكلمة”.
*****
لا أدري ما سرّ الطعام الذي تعده الأمهات خصوصاً إذا كان يمكن لأي شخص إعداده، وها هي هنا من جديد وهكذا فأنا الآن آكل إفطاراً من الزمن الماضي على مائدة من الزمن الماضي مع أم من الزمن الماضي. قالت: تمهل لكيلا تصاب بمكروه. كان ذلك أيضاً من الزمن الماضي”.
*****
“ويومٌ إضافي نقضيه مع شخص نحبّه، يمكنه أن يغيّر كل شيء”.
*****
“عندما يسكن شخص ما في قلبك، فإنه لا يرحل مطلقاً، ويمكن أن يعود إليك حتى في أكثر الأوقات التي تستبعد أن تراه فيها”.
*****
“عندما يعود للظهور أمامك حبيب فقدته، فإن عقلك هو من ينكر الأمر، وليس قلبك”.
*****
“كنت أحلم بعثوري على أبي. أحلم بأنه قد انتقل إلى المدينة المجاورة لنا تماماً. وأنني ذات يوم سأركب دراجتي إلى منزله وأطرق بابه وأنه سيقول إن الأمر كله كان خطأ رهيباً. وأننا سنركب الدراجة معاً عائدين للمنزل، أنا في المقدمة وهو يبدل بقوة خلفي، وأن أمي ستجري للباب الأمامي وتنهمر منها دموع الفرح. كم هي مدهشة شطحات الخيال التي يصنعها عقل المرء. والحقيقة أنني لم أعرف أين يعيش أبي ولم أعثر عليه قط. كنت أمر بمتجره بعد المدرسة، لكنه أبداً لم يكن هناك. كان يديره الآن صديقه مارتي، وأخبرني أن أبي صار يعمل طوال الوقت في المكان الجديد في “كولنجزوود“. كان على بعد ساعة واحدة فقط بالسيارة، ولكن بالنسبة لصبي في عمري، كان بعيداً بُعد القمر والنجوم. بعد فترة توقفت عن المرور بمتجره، وتوقفت عن الحلم بعودتنا معاً إلى البيت على الدراجة. أنهيت المدرسة الابتدائية، والمرحلتين الإعدادية والثانوية دون أي اتصال بوالدي.
كان مجرد شبح. لكني كنت لا أزال أراه. كنت أراه كلما أرجحت مضرباً أو ألقيت بكرة. لهذا السبب لم أقلع قط عن لعبة البيسبول. ولهذا خلال كل موسم ربيع وكل موسم صيف. لعبت مع كل فريق ممكن وفي كل دوري. وكان بوسعي أن أرى أبي في أرض الملعب. يصحح وضع مرفقي. ويصحح وقفتي بالمضرب. كان بوسعي أن أسمعه يصيح: «هيّا، هيّا». وأن أنطلق ركضاً وراء كرة منخفضة. يمكن لصبي على الدوام أن يرى أباه في ملعب بيسبول. وفي عقلي، كان ظهور أبي فعلياً هو مجرد مسألة وقت. وهكذا، فعلى مدى عام، بدلّت أكثر من زيّ لفرق مختلفة وفي كل مرّة ساورني الشعور بأنني أرتدي ملابسي استعداداً لزيارة. وانقسمت فترة مراهقتي ما بين رائحة أوراق الكتب، وهي ما كان يمثل الولع الخاص بأمي، وبين رائحة الجلد لقفازات البيسبول، وهو ما كان يمثل الولع الخاص بأبي. نما جسدي وشب متخذاً هيكل أبي، عريض الكتفين، ولكن أطول قامة ببوصتين فقط. كلما مرّت السنون، كنت أتشبث بلعبة البيسبول وكأنها طوق نجاة في بحر هائج، وكلي إخلاص وإيمان بها رغم كل تقلبات الزمن. حتى أعادت لي أبي في آخر الأمر.
ظهر أبي من جديد، بعد غياب ثمانية أعوام، في أول مباراة لي بالجامعة في صيف 1968، كان جالساً في الصف الأمامي من المقاعد على اليسار مباشرة من قاعدة الرامي. بحيث يتسنى له من هذا المكان أفضل رؤية لشكلي. لن أنسى ذلك اليوم ما حييت، كان يوماً كثير الرياح وكانت السماء تتشح بلون معدن قاتم، وتنذر بسقوط المطر، ليس من عاداتي أن أنظر إلى المقاعد، ولكنني لسبب ما نظرت نحوها، وكان هو هناك حيث ضرب الشيب مقدم رأسه وبدت كتفاه أصغر حجماً، وخصره أعرض قليلاً، كما لو أنه غاص في جسمه وفيما عدا هذا، بدا كما هو، حين كان يشعر بالانزعاج، لم يكن يُظهر هذا، لست متأكداً على أي حال إذا ماكنت سأتعرف على نظرة الانزعاج الخاصة بأبي.
أومأ برأسه نحوي، وبدا وكأن كل شيء قد تجمد. ثمانية أعوام، ثمانية أعوام بلياليها ونهارها. شعرت بشفتيّ ترتجفان تذكرت صوتاً في رأسي يقول إياك أن تفعل هذا يا تشيك، إياك أن تبكي، أيها الوغد، إياك والبكاء.
نظرت نحو قدمي. أجبرتها على الحركة. وأبقيت بصري مثبتاً على قدمي حتى وصلت إلى مربع حامل المضرب، ثم ضربت الرمية الأولى نحو حائط الملعب الأيسر.
الشيء غير المفاجئ أن أبي قد اختفى مع انتهاء مهنتي كرياضي. ومع مرور الوقت راحت موضوعات الحديث بيننا تقل وتقل، باع متجره وابتاع نصف سهم في شركة مساهمة. لم يكن لهذا أية أهمية. كان البيسبول هو أرضنا المشتركة، وبعيداً عنها. تفرقنا مثل قاربين اتخذ كل منهما مجرى مختلفا عند تفرّع النهر. وبالضبط وبنفس اليُسر الذي في حياتي تحت السماء الغائمة لفترة عاد الرجل العجوز ليختفي في ضباب البُعد”.
*****
“كنت في التاسعة من عمري، في المكتبة العامة، كانت أمينة المكتبة امرأة تجلس خلف المكتب تنظر من فوق تنورتها، اخترت كتاب “عشرون ألف فرسخ تحت الماء” بقلم المؤلف “جول فيرن”، فقد أعجبتني رسوم الغلاف وأعجبتني فكرة الأشخاص الذين يعيشون تحت المحيط. لم ألتفت لمقدار ضخامة الكلمات، أو مدى تباعد الكلمات، راحت موظفة المكتبة تدرسني بعينها قميص خارج السروال، وحذاء مفكوك الرباط.
قالت: “هذا صعب جداً عليك”.
شاهدتها تضع الكتاب على رف خلفها. ربما كان عليها أن تخبئه في خزانة. عدت إلى قسم الأطفال واخترت كتاباً مصوراً يحكي عن قرد. عدت لمكتبها. وختمت لي هذا الكتاب دون تعليق. حين جاءت أمي بالسيارة، جلست منكمشاً في المقعد الأمامي. ورأت الكتاب الذي اخترته.
سألت: ” ألم تقرأ هذا الكتاب من قبل؟”
“لم تسمح لي السيدة بأن آخذ الكتاب الذي أردته”.
“أي سيدة؟”.
“موظفة المكتبة”.
أوقفت محرك السيارة.
“ولماذا لم تسمح لك باستعارته؟”.
“قالت إنه صعب جداً عليّ”.
“ما الشيء الصعب جداً؟”.
“الكتاب”.
أمسكت بي أمي وأخرجتني من السيارة. سارت بي خلال الباب حتى وصلنا إلى المكتب.
“أنا السيدة بينيتو. هذا ابني تشارلي. هل أخبرته أن أحد الكتب تصعب قراءته عليه؟”.
تخشّبت الموظفة. كانت أكبر سناً من أمي بكثير، واندهشت من لهجة أمي في الحديث، مع الوضع في الاعتبار طريقتها المعتادة في التحدث إلى كبار السن. قالت السيدة وهي تمس نظارتها: “أراد استعارة كتاب “عشرون ألف فرسخ تحت الماء” لـ جول فيرن، وهو صغير جداً على هذا، انظري إليه”.
حنيت رأسي، ونَظَرت إليّ.
قالت أمي: “أين الكتاب؟”.
“أستميحك عذرًا؟”.
“أين الكتاب؟”.
مدّت المرأة يدها خلفها، وألقت به على النضد، كما لو أنها تؤكد كلامها بثقله. أمسكت أمي الكتاب ووضعته بين ذراعيّ. قالت أمي بلهجة حادة: “إياكِ أن تخبري أي طفل بأن شيئاً يصعب عليه. وإياكِ، إياكِ أن تفعلي ذلك مع هذا الطفل بالذات”.
الشيء التالي الذي أدركته أنني خرجت الباب، أحتضن كتاب “جول فيرن” بقوة، وشعرت كما لو أنني أنا وأمي سطونا على مصرف، وتساءلت ما إذا كنّا سنواجه أي متاعب بسبب ذلك”.
_____________
* ميتش ألبوم، صحافي وكاتب أمريكي، تمت ترجمة أعماله لـ42 لغة، وبيع منها أكثر من 35 مليون نسخة. كل ما سبق، مقتطف من رواية “ولو ليوم واحد آخر”.
عدد المشاهدات : 2589
شارك مع أصدقائك
2 Comments