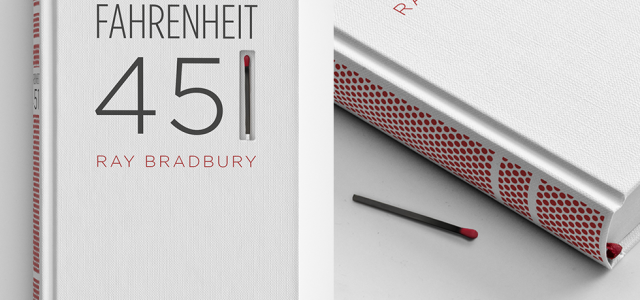451 فهرنهايت | سمير عطالله
مدير التحرير
للكوارث علامات تحدّد أنواعها. بطل “الطاعون” لألبير كامو، أدرك أن الوباء قد وصل عندما أفاق ووجد جرذاً نافقاً على مدخل المنزل. عندما أُحرقت “مكتبة السائح” في طرابلس اسودّت أمامي الدنيا. إحراق الكتب فيه دلالة أفظع من إحراق البشر. علامة التسلسل المتفاقم. مَن يحرق الكتاب لا يرقّ قلبه لشيء. ازدادت الرؤية سواداً في تفجير “مكتبة القدس” في حارة حريك.
ثمة رواية شهيرة من روايات الخيال العلمي عنوانها “فهرنهايت 451” عن مدينة أميركية مهمتها إحراق الكتب. رجال إطفاء وشرطة مهمتهم إحراق الكتب الممنوعة، أي الكتب المنيرة. وورق الكتب لا يحترق إلا على درجة 451 فرنهايت. الدرجة التي يتسخّر فيها العقل وتذوب بقايا الحكمة وتسلّم إلى المطافئ جميع صكوك الفكر. لإحراقها، لا لإنقاذها.
في “فرنهايت 451” يتساوى الموقف من الكتب. ولا يعود من الممكن قراءة كتاب غير ممنوع إلا تحت اللّحاف، خوفاً من المطاردة. وتصبح القاعدة المألوفة هي الظلام والرماد. ويبحث محبّو الضوء عن أماكن آمنة. وضع طبيب أميركي، في الأربعينات، كتاباً عن نوع من الرجال يحصل على كل الكفايات: شهادة من هارفارد. خلفية اجتماعية ممتازة. صداقات في أعلى المراتب، لكنه يفتقر إلى شيء أهم من كل ذلك: الضمير. لذلك، يرتكب كل ما يرتكب بعقل واعٍ. يعرف سلفاً نتائج عمله، ومع ذلك، يُقدم عليه، ثم يُقدم على ما هو أسوأ منه. إنها الدرجة 451 فرنهايت.
إلغاء الكتاب يُفسح في المجال للتخاطب بالموت. تحوّل الرسائل إلى جثث، وتُكتب الشعارات على الجدران بالأشلاء بعد فترة طويلة من كتابتها بالدهان الأسود. لا يعود الدهان ينفع أو يشبع. المسألة أكبر من ذلك بكثير. الدماء تغلي في العروق إلى درجة 451 فرنهايت. وعزيزنا شكسبير، الذي كان عنده لكل مقام مقال، طالما ردد “أن الشيطان مستعد للتلاوة من الكتاب المقدس، إذا كان ذلك يخدم غايته”!
الحروب تبدأ من أجل كلمة، أو بسببها، يقول آرثر كوستلر. لاحظ كيف تبدأ “الإشكالات الفردية” التي تتطور إلى مجازر. أو لاحظ كيف رُويت لنا حرب 1860، التي قيل إنها بدأت بسبب خناقة بين أطفال، وإذا “كلمة من هنا، كلمة من هناك، وصار الدم إلى الرِّكب”.
عندما تعود إلى قراءة الحروب الكبرى، تجد أن محطاتها الرئيسية خُطب: هتلر يُسحر الألمان بلهجة الانتصار، وتشرشل يعبّئ البريطانيين ببلاغة الأدباء، ولا يجد ديغول المنفيّ ما يفعله سوى الكلمة: نداء 19 حزيران عبر الـ” بي. بي. سي.” إلى فرنسا المحتلة.
الحرب الباردة، في بداياتها وذروتها ونهاياتها، كانت حرب الكلام. جون كينيدي يخطب في برلين المحاصرة “أنا من برلين”، ونيكيتا خروشوف يخطب في الأمم المتحدة، مستديراً مثل بطيخة غاضبة، يضرب بحذائه الطاولة أمامه. جمال عبدالناصر يسحَر المصريين ويقودهم سُعداء إلى حربين في عشر سنين، يُهزم ناصر العسكري لكن الملايين تَبكي ناصر الخطيب. ديغول يهزّ أميركا الشمالية إذ يخطب من شرفة البلدية في مونريال: “فلتحيا كيبيك الحرّة”. بدأ خللاً لم ينتهِ بعد.
كان ذلك عصر الراديو. وكما نشر الحدّاد غوتنبرغ الكلمة المطبوعة، نشر العالِم الإيطالي ماركوني الكلمة المسموعة. عندما اخترع ثلاثة أميركيين “الترانزيستور”. العام 1954 تطوّر الراديو كسلاح و”الموجة القصيرة” كجبهة. اخترق الغربيون “الستار الحديد” من خلال راديو “أوروبا الحرة” و”صوت أميركا” وبرامج الـ “بي. بي. سي.” بمختلف اللغات. وعندما قام العسكريون بانقلاب على غورباتشيوف وبوريس يلتسين العام 1991، وسيطروا على الإذاعات الروسية، أرسل يلتسين نصّ خطابه (إلى الجيش) إلى “صوت أميركا” كي يبثّه!
حلّ التلفزيون محلّ الكتاب والراديو. أداة غاضبة يسهل فيها التزوير والتمويه والتعبئة. تتوجّه “داعش” ويتوجّه “المحلّلون” إلى الناس بإيقاع واحد. خرج أحمد سعيد من باب الإذاعة ودخل من باب البث الفضائي. ولكن بأدوات إضافية: المتحاورون يستخدمون أكواب المياه واللكمات وذلك الانحطاط التعبيري الذي صار محظوراً في الأزقّة، أو مأنوفاً في الشوارع. بدأ التلفزيون كأداة توعية وتحوّل إلى أداة تعبئة. لم تعد النشرة الإخبارية تبدأ بالخبر، موضوعياً أو موجّهاً، وإنما بالتحريض والهجوم والتحقير والسخرية. مباراة مُعلنة حول مستمع متوتّر، جالس في الصالة في انتظار أن يهبّ واقفاً عندما يرى الملاكم المعادي قد سقط أرضاً. “صوت العرب” كانت له مساوئ لا تُحصى، لكن السوء الطائفي لم يكن بينها. وكانت له تبذّلات كثيرة، لكن البذاءة كانت للحالات الطارئة جداً، أو لتعرّض الأستاذ أحمد سعيد لحالة جفاف قاموسي عابرة، وهو أمر نادر. كان مُستوعَباً من الكلمات.
لا أملك معلومات ولا تقديرات تقريبيّة عن مدى انصراف الناس عن التلفزيون السياسي، لكن هناك شعوراً عاماً، عندك وعندي، بأن أكثرية الناس انصرفت تماماً عن البرامج التي تخالف قواعد مصارعة الثيران. بين نشوء قناة “الجزيرة” وبين ما آلت إليه اليوم، عالم شاسع. فقدت نجوميتها وشعبيتها التي لا سابق لها، عندما تحوّلت من “الرأي والرأي الآخر” إلى الرأي الذي لا رأي سواه. هناك أكثر من ألف فضائية عربية الآن، لكن الأكثرية من الناس تشاهد “أراب آيدول”.
لا تستطيع أن تبقى مكانك وفي الوقت نفسه تُغطي عالماً يتغيّر كل لحظة. طبيعة هذا العالم أنه محطة انطلاق لا محطة انتظار. المكوّن الأساسي والأول للنجاح هو أن تتطوّر مع نجاحك. الكلمة سحر، إذا أسأت استخدامها انقلب على الساحر.
لذلك، بعض الزعماء الخبراء بذلك، لجأوا إلى السحر الآخر، الصمت وقلّة الكلام من حُسن الفطن. أحدهم كان الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. سلطان عُمان يفضّل حتى عدم الظهور إلا في الصورة الرسمية على الجدران. كما للبيان سحره، للصمت ضماناته: “زين”، سمّته العرب، كأنه أحد أولادها.
بعكس العصر الإذاعي، العصر التلفزيوني بابلي. لغط وأي شيء ومحلّلون يحلّون الشتيمة والضرب بالكراسي. ما أوهن التزلّم بالفجور، ما أصفق الحجة بالسبّ، ما هذا الزمان. قال أعظم صحافيي القرن الماضي، “لكي تمتهن الصحافة يجب أن تكون طيباً قبل أي شيء. الرديء لا يمكن أن يكون صحافياً جيداً إذا لم يكن طيّب القلب. فقط الإنسان الطيب يحاول أن يتفهّم الآخرين، ونيّاتهم ومعتقداتهم ومصالحهم وصعوباتهم ومآسيهم. الحقيقة أن الصحافي مترجم، ليس من لغة إلى أخرى، بل من ثقافة إلى أخرى”.
يؤمن المثقفون الأوروبيون بأنه ليست هناك ثقافة أهمّ من أخرى، بل هناك ثقافات مختلفة. هناك إنسانيات مختلفة. لكن الحطّابين لا يدركون ذلك. المهم أن يُوقدوا النار. في العصر التلفزيوني صارت “فوكس” هي المدرسة والنموذج. الهائج ليس الثور بل صاحب الحلبة. وغالباً الثور أكثر إنسانية من المصارعين.
كابوشنسكي مرة أخرى: “أوائل التسعينات ذهبتُ مع المفوضية السامية للاجئين إلى مخيمات اللاجئين على الحدود السودانية – الأثيوبية حيث عشت تجربة قاسية. دخلنا أماكن هي أقسى ما يمكن أن يتخيّله المرء. كان كل لاجئ يُعطى 3 ليترات مياه في اليوم، لكي يغتسل ويطبخ ويغسل ثيابه ويشرب. ويُعطى لطعامه أوقية من الذُّرة في اليوم، لا لحم ولا خضار. وكان مئات الآلاف يموتون. ثم بعد يومين عدتُ إلى أوروبا بطريق روما، وكانت البياتزا نافونا تعجّ بالحياة والمطاعم والموسيقى والنبيذ والمياه. أنا كانت تلاحقني صُوَر الأمس”.
كيف تراه المشهد السوري من مونترو؟ كانت المدينة الأولى عرفتها في سويسرا، العام 1968. وكان هذا البلد لا يزال يُسمى سويسرا الشرق. لكن النِعَم لا تدوم. بعد عام واحد بدأ كل شيء بالانهيار. رحلة العودة عبر القرون. من مكتبة السائح إلى مكتبة القدس 451 فرنهايت.
عدد المشاهدات : 1145
شارك مع أصدقائك
Comments are closed.